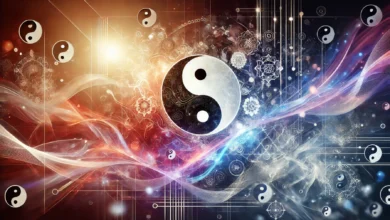(مقال مترجم)

مانليو غرازيانو – 12 مارس 2018
تعريف بالكاتب: مانليو جرازيانو باحث إيطالي متخصص في الجغرافيا السياسية والجغرافيا السياسية للأديان، يُدرّس في معهد باريس للشؤون الدولية، ومعهد العلوم السياسية، وفي جامعة السوربون وفي كلية أوروبا.
مقدمة:
اليوم، لا شك أن الأديان هي أحد العوامل التي تسهم بشكل متزايد في تشكيل وتكييف العلاقات الدولية. وبالتالي، فإن دورها يحتاج إلى الدراسة باستخدام نفس الأدوات وبنفس الدقة التي عادة ما تُخصص للفروع الأخرى من الشؤون السياسية.
الجغرافيا السياسية هي إحدى هذه الأدوات. إذا نظرنا إلى الأديان من وجهة نظر سياسية بحتة، أي كأدوات سياسية بين أدوات سياسية أخرى، يمكننا أن نقول بشكل تقريبي إنه لفهم الظواهر الدولية التي تشارك فيها الأديان، يجب على المرء أن يدرس الجغرافيا السياسية أولاً، وليس الأديان. هذا بالطبع هو تبسيط مفرط، لأن الطبيعة الخاصة بكل دين تجعله أداة سياسية مختلفة، لكن هذا التبسيط يسمح بوضع ترتيب للأولويات من الناحية المنهجية.
لفهم ما نعنيه بشكل أفضل، يمكننا أن نأخذ مثال الشرق الأوسط: إذا أراد المرء دراسة ظاهرة ما يسمى “الدولة الإسلامية“، فيجب عليه دراسة الحرب بالوكالة بين إيران والسعودية وتركيا وقطر التي تهدف إلى السيطرة على سوريا الكبرى ودور القوى العظمى التقليدية، وليس القرآن. في هذا الصراع، تكون السيطرة على سوريا الكبرى هي الهدف، ويُعتبر القرآن أحد الوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الهدف.
على العكس من ذلك، حاول الكثيرون تفسير أحداث الشرق الأوسط من خلال الصراع التاريخي المزعوم بين المسلمين السنة والشيعة. ومع ذلك، في العصر الحديث، حتى الثورة الإيرانية عام 1979، لم تكن هناك مواجهات كبيرة بين المجتمعات السنية والشيعية. حتى عام 1979، كانت إيران والمملكة العربية السعودية على نفس الجانب من الحرب الباردة وأدوارهما الدولية منعتهم من القتال ضد بعضهم البعض للهيمنة في المنطقة. بعد عام 1979، كان أفضل مسار للسعوديين (في محاولة) لتحقيق التوازن في علاقاتهم غير المتكافئة مع إيران هو استغلال السنة (الذين يمثلون حوالي 90% من العالم الإسلامي) ضد الشيعة (الـ 10% الباقية أو نحو ذلك).
كل دين في كل مكان هو موضوع استغلال سياسي لأغراض لا علاقة لها بخلاص الروح. كما كتب غراهام فولر: “سيتم استدعاء الدين دائمًا حيثما يمكن ذلك لتحفيز الجمهور وتبرير الحملات الكبرى والمعارك والحروب”، لكن “الأسباب، والحملات، والمعارك، والحروب ليست حول الأديان.” (عالم بدون إسلام، 2010).
هذا ممكن لأن النصوص المقدسة يمكن أن تخدم كأدوات سياسية مرنة جدًا. باستخدام النصوص المقدسة لأي دين، يمكن بالفعل دعم كل الأطروحات ونقيضها. خلال المناقشات القاسية حول العبودية في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر، استخدمت القوى المؤيدة والرافضة للعبودية الاقتباسات الكتابية بشكل كبير لدعم وجهات نظرها. صرح جاك برلينربلاو، الباحث في جامعة جورجتاون الذي درس استغلال الكتب المقدسة في السياسة الأمريكية، بأن “الكتاب المقدس يمكن دائمًا أن يُستشهد به ضد نفسه، بغض النظر عن الموضوع… الكتاب المقدس للتداول السياسي الواضح والمتماسك مثل الجليد، والضباب، والبرد، والسيول المفاجئة لسلامة الطرق السريعة.” (Thumpin’ it: The Use and the Abuse of the Bible in Today’s Presidential Politics, 2008).
***
الدور السياسي للأديان:
عندما يتعلق الأمر بالدور السياسي للأديان، فإن التمييز الأهم هو بين الأديان السلبية والأديان الفاعلة. الأديان السلبية هي تلك الأديان التي لا يمكنها اتخاذ أي مبادرة سياسية مستقلة لثلاثة أسباب على الأقل: 1) تفتقر إلى قيادة موحدة يعترف بها جميع المؤمنين؛ 2) لا تقيم وساطة كهنوتية بين المؤمنين والله؛ 3) لا تحتوي نصوصها المقدسة على تفسير معتمد فريد (مما يمنعها من أن يُستشهد بها ضد نفسها). في المقابل، تتمتع الأديان الفاعلة بالخصائص المعاكسة: 1) لديها قيادة يعترف بها جميع المؤمنين؛ 2) لديها وساطة كهنوتية بين المؤمنين والله؛ 3) نصوصها المقدسة تحتوي على تفسير معتمد فريد. فقط الأديان الفاعلة يمكنها اتخاذ مبادرات سياسية مستقلة.
السنة، الهندوسية، اليهودية، والإنجيلية – من بين آخرين – هي أمثلة على الأديان السلبية. لا يمتلك أي منها مركزًا دينيًا أو قائدًا دينيًا يعترف به جميع المؤمنين، وتسمح لكل مؤمن (أو مجموعة من المؤمنين) بقراءة وتفسير النصوص المقدسة بطريقة شخصية (أو فئوية). عندما تصبح هذه الأديان أدوات سياسية، يمكن لكل مؤمن أن يدعم جميع الأطروحات ونقيضها، يمكنه دعم الإرهاب أو قطع رؤوس غير المؤمنين، أو باستخدام نفس النص المقدس، يمكنه الالتزام بالتواضع والانسجام الشامل بين البشر. نصوصهم المقدسة “لتداول سياسي واضح ومتناسق مثل الجليد، والضباب، والبرد، والسيول المفاجئة لسلامة الطرق السريعة.”
إلى حد ما، تعتبر الكنائس الأرثوذكسية المسيحية وغيرها من الكنائس المؤسسة أيضًا مؤسسات دينية سلبية، ولكن لأسباب مختلفة. لأنها مرتبطة بشكل جوهري بالسلطة السياسية وتخضع لها، فهي ليست مسموحًا لها باتخاذ أي مبادرة سياسية مستقلة.
بإيجاز، يمكننا أن نقول إن المؤسسة الدينية الوحيدة القادرة على اتخاذ مبادرة سياسية مستقلة، الوحيدة الفاعلة، هي الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. كما قال كاردينال مجهول في مقابلة طويلة مع صحفي فرنسي: “نحن بلا شك نؤثر على المسرح العالمي كلما سنحت الفرصة… نحن السلطة الدينية الوحيدة التي تستطيع فعل ذلك. فقط الكنيسة الكاثوليكية لديها سفارات رسمية في جميع دول العالم تقريبًا [وكذلك] قيادة فردية ومركزية. نحن معتادون جدًا على ذلك لدرجة أننا غالبًا ما ننسى مدى استثنائية حالتنا.” (Confession d’un cardinal, 2007). هذا الوصف صحيح، على الرغم من أن شبكة السفارات التابعة للكرسي الرسولي حول العالم هي أكثر من نتيجة لقوتها من كونها مصدرًا لها. بل إن مصدرها يكمن في تاريخها، في تنظيمها، وقبل كل شيء في خبرتها الطويلة في الشؤون الإنسانية، وخاصة في الشؤون السياسية.
تعود هذه الخبرة إلى زمن تقسيم الإمبراطورية الرومانية. في جزءها الشرقي، كانت السلطة السياسية المركزية قوية وصلبة ولذلك كانت الكنيسة خاضعة للإمبراطورية ومؤسسة منها. كان الإمبراطور نفسه هو القائد الفعلي للكنيسة، حتى في الشؤون اللاهوتية؛ كان يمارس “السلطة العليا في الأمور الكنسية بفضل شرعيته الذاتية” (هذا هو ما وصفه ماكس فيبر، في كتابه “الاقتصاد والمجتمع”، بـ “السيزاروبابيسم”). على العكس من ذلك، في الجزء الغربي من الإمبراطورية الرومانية، حيث كانت السلطة السياسية (سواء المركزية أو المحلية) ضعيفة أو غير موجودة، كانت الكنيسة هي السلطة المركزية وشبكة الأبرشيات الخاصة بها حلت محل الحكم الإمبراطوري المتداعي.
تطورت الكنيسة اللاتينية كمركز للسلطة السياسية المباشرة، وهي خبرة تشاركها مع مجتمعات بوذية مختلفة (ولا عجب أن البوذية والمسيحية اللاتينية هما الجسمان الدينيان الوحيدان اللذان طورا نظرية “الحرب العادلة” بشكل مستقل). وحدها الاختلافات التاريخية في جنوب شرق آسيا وأوروبا الغربية هي التي تفسر لماذا لم تنظم البوذية نفسها في كنيسة مركزية وهرمية مثل الكنيسة الكاثوليكية: الأخيرة كانت قادرة على إنشاء ثيوقراطية، بينما الأولى كانت قادرة على إنشاء العديد من الثيوقراطيات. هذا التفكك جعلها فريسة سهلة للسلطة السياسية العلمانية.
***
عودة الأديان:
عادت الأديان إلى المجال العام في السبعينيات. كما لاحظ جيل كيبل في عام 1991، “كانت السبعينيات عقدًا محوريًا للعلاقات بين الدين والسياسة” (La Revanche de Dieu، 1991). ماذا حدث في هذا العقد؟ في العالم “النامي”، دفعت صناعية الزراعة إلى هروب جماعي من الريف والتحضر، وتزامنت هذه الاضطرابات الاجتماعية مع الأزمات السياسية في العالم ما بعد الاستعماري. في الدول “المتقدمة”، وضعت أزمة 1974-1975 حدًا لـ “الثلاثين المجيدة”، ثلاثين عامًا من النمو الاقتصادي شبه المستمر بعد الحرب العالمية الثانية، وفتحت حقبة جديدة من مبادئ السوق الحرة حيث تسارع تراجع الدولة “الويستفالية” التقليدية.
في هذه الدول “المتقدمة”، عادت الأديان بوتيرة تتناسب عكسًا مع مصداقية الدولة (وأي أيديولوجية وعدت بالتقدم والرفاهية). كلما أصبحت الدول أقل فعالية في تقديم المعنى والخدمات الاجتماعية لمواطنيها (وغالبًا ما تكون الأخيرة هي الضمانة الأفضل للأولى)، زادت احتمالية
في الدول “النامية”، كان عودة الأديان أكثر فجائية لأن عمليات التصنيع (الهروب من الريف والتحضر) كانت سريعة للغاية وغالبًا ما كان لها تأثيرات مدمرة. بالنسبة لملايين الفلاحين المتحضرين، كان الحفاظ على رابط حي مع تقاليدهم الريفية – مع شبكات عائلاتهم – غالبًا ما يكون الفرصة الوحيدة للبقاء الاجتماعي. في الأحياء الفقيرة في المدن التي أصبحت مكتظة بالسكان، بنيت مساجد جديدة بوسائل مؤقتة. حاولت الجمعيات الخيرية الدينية تعويض بعض النقص في البنية التحتية وحاولت توفير الوصول إلى بعض المساحات الآمنة والمسيطر عليها للسكان. رأت الحكومات في هذه الأشكال من “التدين الشعبي” كلا من الحماية ضد مخاطر الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، وحلاً لعجزها عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
خاتمة
في السبعينيات، تعرضت حياة سكان الدول “المتقدمة” وسكان الدول “النامية” للاضطراب. عندما تقاربت هاتان العمليتان، كان الاستغلال السياسي هو العامل المفجر لعملية إزالة العلمنة التي كانت لا تزال كامنة. في البداية، كان هناك عدد قليل من الناس الذين تمكنوا من تحديد هذا الدور السياسي الجديد للأديان؛ اليوم، أصبح جزءًا من مشهدنا اليومي، وأصبح من المستحيل تقريبًا الحصول على رؤية واضحة للحياة السياسية الحالية إذا تجاهلنا دور هذا الفاعل القوي.
**