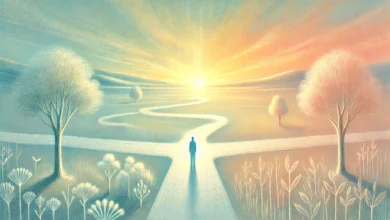الوعد الأول: “الجوس خلال الديار” (1/3)
باعتباره تحققا واقعيا ل”السابع من أكتوبر”
-قراءة مستجدة في قوله تعالى: ﴿فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ﴾-
(فلسطين خلال الوعدين: قراءة سيميائية استشرافية من الوعد بالبعث إلى الوعد بالتتبير)
بقلم: ماهر الملاخ
مقدمة المقالات الثلاث: في فواتح سورة الإسراء، يختصر الوحي تاريخ العلوّ الإنسانيّ كلّه في قصة بني إسرائيل؛ لا بوصفهم قومًا من الماضي، بل نموذجًا دائمًا للانحراف السننيّ: قومٍ مُنحوا النعمة فحوّلوها نفوذا وتسلطا، وأُوتوا الهداية فبدّلوها تحريفا ومكرًا. وحين يتحوّل الوحي إلى امتياز، تبدأ سنّة الله في العمل؛ إذ يُبعَث عبادٌ لله ليعيدوا الميزان، ثم يُمهَل العلوّ ليتدحرج في دركات اغتراره، ثم يُعاد التوازن بالتتبير، واسترجاع قيمة العدل والرحمة.تتحرّك فلسطين في قلب هذه السننية، لا كجغرافيا للصراع، بل كبنيةٍ رمزيةٍ لاختبار المعنى. فما بين “الوعد الأوّل” و”الوعد الآخر” يتكشّف قانون التدافع في التاريخ: أن تُبعث طليعة أهل الحق في لحظة من الوعي، وأن تُردّ الجولة لصالح أهل الباطل ليزدادوا اغترارا، ثم يُتَبَّر ما أعلوه تتبيرًا. ومن هنا تأتي المقالات الثلاث، كلّ واحدةٍ منها فصلٌ من فصول الصيرورة الكونية في دلالتها القرآنية: المقال الأول: “الوعد الأوّل – الجوس خلال الديار، تحقّقٌ واقعيّ ل” السابع من أكتوبر”، قراءةٌ مستجدّة في قوله تعالى: ﴿فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ﴾”. ويمثّل هذا المقال لحظة البعث، حيث تنقلب المعادلة لأول مرة، ويتحوّل الضعف إلى فعلٍ سننيٍّ منضبطٍ بمشيئة الله. فـ“الجوس” ليس اعتداء، بل تحقيق رسالي لكسر عنجهية الباطل، وإنذارِه بأنّ زمن حصانته قد ولى. إنه الوعد الأوّل الذي به تبدأ جولة جديدة في الصراع بين عدل والظلم. المقال الثاني: “بين الوعدين – ردّ الكرّة، توقّعٌ استشرافيّ لهدنة الطوفان، قراءةٌ مستجدّة في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾.” هذا هو طور الاستدراج بالعلوّ: حيث يبدو الباطل منتصرًا في الظاهر، لكنّ الباطن السننيّ يعمل على إضعافه من داخله. إنها المرحلة التي يُغدَق فيها على الكيان بأسباب القوة، تمويلا وتسليحا، ويُحاصَر فيها أهلُ الحقّ بالإعمار المشروط، لكنّ كِلا الجانبين يسير نحو تنفيذ توازن خفيّ: بأن العلوّ نحو تَبَرِه، والحقّ نحو تمكينه. هي هدنةٌ ظاهرها احتواء أهل الحق، إلا ان باطنها إعداد الأرض للجولة الحاسمة. المقال الثالث: “الوعد الآخر – تتبير الهيكل، توقّعٌ استشرافيّ لزوال إسرائيل، قراءةٌ مستجدّة في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾”. هنا تبلغ السنّة أوجها: فالبناءُ الذي أُقيم بحجارة العدوان سيفكك بمحاول العدل. ولن يكون تفكيكه مجرد فعل مادي، بل إعادةُ تجسيد معنوي. فبعد أن يكتمل بناء الهيكل الثالث، سيُفتضح أمام الجميع زيف قداسته المصنوعة، لتبدأ مرحلة الدخول العمريّ، دخول رحمة بعد محنة قد طالت، ليُفكَّك الهيكل من الأعلى لا من الأسفل، فيتحقّق وعدُ التتبير، وتبدأ دورة الاستخلاف الإنسانيّ من جديد.

المدخل التأويلي: انفتاح النصّ على الحدث:
ليس النصّ القرآني ذاكرةً منغلقةً على الماضي، ولا خطابًا طقوسيًّا يتردّد بتكرار التلاوة في الحاضر، بل كائن دلاليّ متجدّد، ينهض في كل عصر ليقرأ العالمَ من جديد، بالقدر نفسه الذي يُتلى به. فهو ليس كلمات تترصّد حدثا تبرّر به شرعيتها، بل سننا تتحكم في حركة الوجود تضبط به اتجاهه. ومنذ نزوله، احتفظ القرآن الكريم بطاقةٍ تأويليةٍ لا تحدّها الأزمنة، لأنه لم يُنشأ ليصف الوقائع الماضية، بل ليكشف البنية السننية التي تتحرك بها الوقائع جميعها، في الماضي والحاضر والمستقبل. إنّه نصّ لا يُفسَّر من خارجه، بل هو من يفسِّر ذلك الخارجَ، وهو لا يُستَحضر ليستمدّ من الحدث تأويله، بل يستدعي الحدثَ ليكشف من خلاله عن انتظام سنن الله في التاريخ، فيعطيه هويتَه الحقيقية، حينما تلتبس التآويل في فهم ما يحدث.
وحين تتقاطع لحظةٌ تاريخيةٌ استثنائية مع كلمةٍ قرآنيةٍ ظلّت معلّقة في أفق المعنى لقرونٍ طويلة، فإنّ ما يحدث لا يكون “تطبيقًا” مجازيا للنصّ، بل تحقّقٌ دلاليّ لمعناه؛ أي حينها تنتقل العلامة من مستوى الإمكان التأويلي إلى مستوى الوجود التاريخي، حيث يتجسّد المضمون في حركة الزمن. وهنا تتجلّى وظيفة القرآن كـ”نظام دلالي متجدّد” لا يقدّم للإنسان معاني جاهزة، بل يُنزّل شروط تفعيله في التاريخ.
بهذا المنظار، لا يُمكن النظر إلى السابع من أكتوبر 2023 بوصفه حدثًا عسكريا فحسب، بل كـ واقعة تأويلية، أعادت فتح النصّ القرآني على نفسه، واستخرجت من عمقه ما تراكم فوقه من سكون التفسير التقليدي. لقد تجلّت في ذلك اليوم بنيةٌ قرآنيةٌ طال إغفالها في التراكم التفسيري، فإذا بها تعود، دون استئذان من مفسّريها، لتعمل في الواقع: إنها هنا، بنية “الجوس خلال الديار“ والتي وردت في سورة الإسراء.
هذه العبارة التي ظلّ كثير من المفسرين يحصرونها في وقائع الغزو البابلي أو الروماني، تتجلّى اليوم بوجهٍ جديدٍ ينسجم مع نظامها اللغوي والسنني، حين نقرؤها في ضوء فعلٍ واقعيٍّ محدَّدٍ، جسّدها بأقصى دقّتها الحركية: دخولٌ محدود، منظّم، في عمق الأرض المحتلّة، يتلوه انسحابٌ بوعيٍ سننيٍّ لا استيطانيّ.
هناك، فُتحت الآية من جديد، لا لأنّ كثيرا من المفسّرين قد جانبوا في تأويلهم التاريخي هذا الاتجاه فحسب، بل لأنّ التاريخ نفسه استدعاها لتفسّر ما حدث، بلغته الجديدة: ففي لحظة الجوس الحديثة تلك، لم يكن الفعل العسكري مجرّد هجوم، بل فعل دلاليّ أعاد ترتيب العلاقة بين النصّ والواقع، بين العلامة والتاريخ. وهنا تبرز اللحظة الفارقة: أن الآية الكريمة لم تستعد حضورها القَدَري، من خلال تفاصيل ما حصل، بل إن الحدث نفسه هو من استعان بها لتأويل حقيقة ما حدث.
وبهذه المناسبة، يفرض علينا هذا الانبثاق التأويلي إعادة النظر في مفهوم العلاقة بين النصّ والواقع، فليست العلاقة بينهما علاقة إسقاط، بل علاقة تبادلية بين النصّ، بوصفه منطقًا دلاليًا متعاليًا؛ وبين الواقع، بوصفه تجلّيًا سيميائيًا لذلك المنطق. وحين تتوافق البنية الحركية للفعل الإنساني مع البنية السننية للآية القرآنية، يولد ما يمكن تسميته بـ “التواطؤ الدلالي” بين التنبؤ والتحقّق، أي بين اللحظة التي يتّحد فيها اللفظ بالزمن، والمعنى بالفعل، فتتحقّق الآية أخيرا في التجلّي، بعدما ظلت أزمانا متمثّلة في التلاوة.
وهكذا، يصبح “السابع من أكتوبر” مفتاحًا مرجعيّا لإعادة فهم النصّ القرآني، لا بوصفه سردًا لماضٍ قد انقطع وانتهى، بل نظامًا مفتوحًا على تحقّقات سننيةٍ تتجدّد وتتكرّر، تظهر في التاريخ كلما اجتمعت شروط إنفاذها: من علوّ وإفساد وبعث وجوس وتتبير. إنه تحقيق لرد الله الظلمَ بالناس، بعد أن يبلغ العلوّ مداه، حتى لا تفسد الأرض.
إنها ليست دورة تدافع عسكري، بل دورة توازن دلالي، يتحرّك فيها المعنى القرآني في التاريخ، ليُعيد ضبط ميزان العدالة الإلهية في الجغرافيا.
ويُضاف إلى الصفة السننية العامة لآية الجوس، صفةٌ الخصوصية التاريخية للحدث: إذ ليست الآية مطلقة في موضوعها، بل موجَّهة إلى قومٍ مخصوصين، هم بنو إسرائيل؛ ومحدَّدة بفعل مخصوص وهو الجوس، ومتعلّقة بفاعلين مخصوصين وهم “عباد لله”، بعَثهم لتحقيق هذه النبوءة القرآنية، التي ظلّت كامنةً في ثنايا صفحات التاريخ، أربعة عشر قرنًا، حتّى تفعّلت في مكانٍ محدّد، هو مستوطنات غلاف غزة، وفي زمانٍ معيَّنٍ، هو صباح السابع من أكتوبر.
أولا: تاريخ الدلالة: من الغارة إلى التجاوز:
لا يمكن قراءة فعل “جوَسَ” في القرآن الكريم إلا بوعيٍ تأريخيٍّ لمساره اللغوي، لأنّ الجذر ذاته كان كائنًا حيًّا قبل نزول الوحي، تنقّل عبر العصور بين ميادين الحرب والرحلة، ثم ارتقى في سلّم الوعي حتى بلغ التجاوز الرمزي.
ففي الشعر الجاهلي، عند الشاعر عبيد بن عبد العزّى السلامي الأذري، حمل اللفظ معنى الاختراق الحربي المحدود حين يقول:
“ونحن قتلنا في ثقيفٍ وجوّستْ /// فوارسُنا نصرًا على كلّ محضرِ”
إن فعل “جوّست” هنا لا يعني التدمير، بل التوغّل المقاتل داخل ديار العدو، ثم الانسحاب؛ أي دخول قصدي متكرّر في عمق المجال المعادي بغرضٍ محدد. المعنى ليس في “الاجتياح”، بل في “التوغّل المنضبط”
ثم يتطور الجذر عند ابن مقبل العجلاني (37هـ) إلى معنى الحركة في الأرض دون قصدٍ عدائي، فيقول: “ذُعرت بجوس نهبلة قذافٍ”.. فيغدو الجوس مرادفًا للتجوّل الاستكشافي، أي حركة داخل المجال بلا نزعة تخريبية.
وفي القرن الثاني الهجري، يعيد محمد بن عائد الدمشقي عبر كتاب” الصوائف” توجيه المعنى نحو الاختراق المنظّم، فيقول: “فحُسْتَهُم جوس قرمٍ ما يُقيلهم بالخيل تنقض أوتارًا بأوتار“. إنه جوس المقاتل الواعي، لا الغازي المنفلت، وهو ما سيأخذ في العصور المتأخرة معنًى رمزيًا عند ابن السيد البطليوسي (529هـ) حين يقول: “وسمى للعُلا… وجاسهم أي جابهم.“، ليصبح “الجوس” فعلًا فكريًّا في فضاء التجاوز، أي اختراقًا لحدود المعرفة.
هكذا، يتدرج الجذر من الغارة إلى التجوال إلى الاختراق المنظّم إلى التخطّي الرمزي. وما بين هذه الدلالات المتتابعة، يظلّ “الجوس” فعلًا يجمع بين النفاذ في المكان والوعي بالحدود، أي أنّه توغّل لا يتحول إلى احتلال، واقتحام لا يتحوّل إلى استيطان، وهذا بالضبط ما يُميّزه عن مفردات مثل غزا، اجتاح، أو دمّر.
ومن هذا المنظور، يصبح اختيار اللفظ القرآني في قوله تعالى: ﴿فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ﴾ فعلاً مقصودًا دلاليًّا لا يمكن استبداله. إنه الفعل الذي يحتفظ بالمفارقة بين الدخول والانسحاب، بين القوة والانضباط، بين الحضور المؤقت والرسالة الدائمة.
ثانيا: من الغزو إلى الجوس: تصحيح لفهم الآية:
يمكن الجزم بأن كثيرا من المفسّرين قد أغفلوا هذا الاتجاه من التأويل، حين أجروا على هذه الآية منطق التاريخ السياسي، بدل منطق الدلالة القرآنية المراعية للدلالة اللغوية، فجعلوا “الجوس” مرادفًا للغزو البابلي أو الروماني، وأسقطوا عليه أوصاف الاجتياح والإفناء، بينما اللفظ في ذاته لا يحتمل هذه البنية التدميرية. ف”الجوس” في لسان العرب ليس فعلاً إمبراطوريًّا، بل فعلاً تطهيرياً، وهو من سنن الله في ردّ الظلم بالعدل.
من هنا، يجب التمييز بين غزوٍ استعماريٍّ يوسّع النفوذ الأرضي، وجوسٍ سننيٍّ يضبط ميزان الحقّ في الأرض.
فالغزو ينتج عن طموحٍ دنيويٍّ يسعى إلى الاستحواذ، أمّا الجوس القرآني فهو فعل إصلاحي جزائي يبعثه الله على أقوامٍ بلغوا ذروة الفساد والعلوّ، ليعيد التوازن الأخلاقي في التاريخ.
ومن هنا يتجلّى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ﴾. إنّ فعل “بعثنا” هو المفتاح المفهومي لهذا المشهد السننيّ؛ وهو مختلف تماما عن الفعل “سلّطنا“، وقد كان بالإمكان استخدامه. غير أن “البعث” في لسان القرآن مفارق للتسليطٍ القهريٍّ و التحريكٍ الإمبراطوريّ، وإنما هو تكليف رساليّ يحمل معنى المهمة السامية، لا الغزو والسيطرة. و”عبادٌ لنا” ليسوا قوة عسكرية تُديرها المصلحة السياسة، فلا يليق بهم غير تكليفٍ إلهيٍّ ولو كان مؤقتا وضمنيا. فهم يُبعثون ليؤدّوا وظيفةً، ضمن نظام العدالة الكونية. لذلك جاء فعلهم محدودًا بحدود الرسالة، لكن مفعوله كان نفاّذا عميقا في بينة العلوّ: (فجاسوا خلال الديار) بحركةٌ استكشافيةٌ إنفاذية، لا اجتياح فيها ولا إبادةً، تعمل على إثارة وجه الحق بالحق،وكشف وجه العدوان بالتحدّي، وردّ موازين القسط إلى مواضعها الأولى. فبذلك يكون كلّ تأويلٍ يردّ “البعث” إلى معنى القهر الماديّ، أو يحيل “الجوس” على معنى التدمير الشامل، يُفرّغ النصّ من دقّته القرآنية، ويحوّله من نظام تكليفٍ إلى نظام تسليطٍ، بينما هو في جوهره إعلانٌ عن لحظة بعثٍ رساليٍّ
ثالثا: “السابع من أكتوبر” التحقّق الدلاليّ الوحيد لجوس ديار بني إسرائيل:
إنّ ما وقع في السابع من أكتوبر 2023 لم يكن مجرّد معركةٍ عسكرية، بل تجلٍّ سننيٌّ لمعنى قرآنيٍّ ظلّ معلّقًا ينتظر لحظة تحقّقه. وحين اجتمع في ذلك اليوم فعلُ الدخول المحدود، والتنقّل المنضبط، والانسحاب الواعي، والإعلان الصريح عن مرجعية التوحيد.. دون أن تؤثر الانفلاتات الجانبية على حقيقة الجوس.. فقد انطبقت البنية الحركية للحدث مع البنية الدلالية للآية انطباقًا شبه تام.
لقد تجسّد في ذلك اليوم، ولأول مرة في تاريخ بني إسرائيل، ما يمكن أن نسميه بـ “التحقّق الدلالي للعلامة القرآنية”، أي انتقال اللفظ من فضاء الإمكان التأويلي إلى فضاء التجسّد التاريخي. إنها لحظة تفاعل النصّ مع الواقع لا عبر التفسيرالمحتمل، بل عبر التحقيق الناجز؛ إذ أصبح الحدث نفسه تأويلًا حيًّا للآية. وهو ما يجعل هذا التوافق ليس مجرد صدفة، بل انفعالًا سننيًّا، تُعيد به السنّةُ الإلهية تشغيل نفسها في التاريخ، متى ما تكرّرت علُلها: إفسادا متوُّجا بعلو، وعلوّا متحدَّيا بجوس. وفي حالة بني إسرائيل، لا يوجد أبدا، وفي كل تاريخهم، الممتد 27 قرنا، بين الإفساد الأول (القرن 7 ق.م) إلى الإفساد الثاني (القرن 1 م) إلى بداية العلو (1948) ثم تمادي العلو (1967).. إلى حدود ليلة السابع من أكتوبر… ما تنطبق عليه تفاصيل حدث الجوس كما وردت في الآية، سواء باستحضار طبيعة الفعل (فجاسوا خلال الديار)، أو هوية الفاعلين (عبادا لنا)، أو سياق الفعل (ولتعلونّ علوا كبيرا).
بهذا المعنى، لا يُمكن القول إن المقاومة قد قرأت الآية ثم عملت على تحقيقها في الواقع، فجلّ التفاسير لم ترمِ سابقا إلى هذا المنحى، بل إن الآية، باعتبارها قضاء ربانيا واجب الإنفاذ، منذ أن تنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام سنة واحدة قبل الهجرة، هي التي تجلّت في الحدث، بعد أن تحققت شروط التقدير المكتوب. فالتحقّق الدلالي هنا لم يأت بالضرورة من الوعي البشري المباشر بالنصّ، بل من فاعلية الواقع ذاته حين يستوفي شروط تحقق الحدث، فيعود بذلك النص ليُنتج ذاته في الزمن. وفي هذه اللحظة، يصبح التاريخ نصًّا فرعيًّا للقرآن، لا العكس؛ لأنّ النصّ هو العلامة التي تنبّأت بالحدث، فيما مثّل الحدثُ الشكلَ الذي تأطّر داخل بنية السنة الإلهية.
خاتمة تأملية: حين يتكلّم النصّ من قلب التاريخ:
إنّ القرآن الكريم لا يتكلّم من وراء التاريخ، بل من قَلبه: فكلّ حدثٍ كبيرٍ هو مرآةٌ تُعيد للآية حضورها في الزمن، وكلّ دورة حضارية فاسدة تُستدعى فيها سُنّة الجوس من جديد، لا كعقابٍ أعمى، بل كتطهيرٍ من علّةٍ استحكمت في الجسد الإنساني. وقد تخصصت هذه السنة في هذه الحالة في حالة بني إسرائيل يوم الطوفان. وحين يتحقّق الجوس في التاريخ، فإنّ ما يجري ليس مجرّد حركةٍ عسكرية، بل حركة معنى في نسيج الوجود، حيث يستعيد الوحي وظيفته الكونية: أن يعيد للأرض توازنها حين يختلّ.
لقد كان السابع من أكتوبر لحظةً نطق فيها التاريخ السنني بلسان النص القرآني، فعبّر عن نفسه من خلال فعلٍ بشريٍّ مقاوِم، منضبطٍ بالشروط التي حدّدها منذ قرون: عبادٌ لله، أولوا بأسٍ شديد، يجوسون خلال الديار، لا لاحتلالها، بل لإحداث شرخ عميق في بنية العلوّ الكبير، ليدخل ذلك الكيان المستعلي في سيرورة انشراخ مزمن، لن يتوقف إلاّ بتتبيره. بهذا المعنى، لم يكن الحدث استثناءً في التاريخ، بل استئنافًا للسنّة الإلهية التي تعمل في صمت، وتعيد تفعيل معانيها كلّما بلغ العلوّ الإنساني ذروته.
فـ”الجوس” الذي كنا جميعا شاهدين عليه، لم يكن غزوًا ماديًا، بل طعنة عميقة في خاصرة الظلم والاستعباد، من شأنه أن يعيد وصل الإنسان بخطاب السماء. إنه لحظةُ عبورٍ لا عبر أسلاك اغلاف غزة، بل هو هو انتقال من لنصّ المحتمل إلى الحدث المحقّق، ومن القضاء المنتظر إلى القدر المكتوب. وفي كلّ مرّةٍ يتحقّق هذا التوازي، يتجدّد حضور الوحي في التاريخ، كأنه يُتلى لا بالأصوات المسموعة، بل بالمشاهد المرئية، حتى يحرّك مشاعر الوجدان، ويعيد توجيه بوصلة الإنسان.
وهكذا، يغدو السابع من أكتوبر، بدون أي مواربة، هو الحقيقة المتجسّدة في الآية، ويصبح “الجوس خلال الديار” هو الدلالة المتؤوَّلة في الوجود، بعد أن ظلّت قرونًا حبيسة جُنوح بعض التفاسير عن حقيقتها، لتعود اليوم في هيئة فعلٍ، يذكّر العالم بأنّ السنن لا تموت، وأنّ المعنى القرآني لا يخطئ، مهما طال غيابه عن الوعي، لا يتأخّر لحظة عن التجلّي حين يحين أوانه.. ولعلّ أمثاله، من بقية معاني فواتح سورة الإسراء، قد آن أوان تأويلها الآن، وتأويلها حدوثها من عسقلان.
اقرأ المقالة الثانية: فلسطين بين الوعدين: “رد الكرّة“