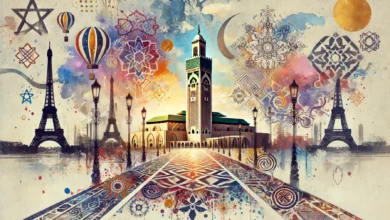فلسطين بين البنية المؤسِسة للاحتلال والإرادة المؤسِسة للتحرير
بقلم: ماهر الملاخ

مقدمة: فلسطين ليست استثناءً، بل مفتاح النظام
يخطئ من يصنف صراع الفلسطينيين ضد الاحتلال الصهيوني ضمن صراع الإرادات، بل هو، وكما سيتضح جليا، صراع إرادة صاعدة ضد بنية قائمة: ففلسطين، لم تكن لحظة احتلالها عام 1948 مجرد ضحية جديدة في سجل النزاعات الدولية، ولا كانت إفرازا نمطيا لصراع جغرافي قابل للحل داخل منطق “النظام الدولي القائم”، وكأنها حالة شاذة قابلة للتسوية. بل لقد مثلت قضية فلسطين في عمقها البنيوي “المحرقة المؤسِّسة” للنظام العالمي المعاصر، ذلك النظام الذي وُلد من رحم الحرب العالمية الثانية، وتوزعت شرعيته وفق معادلة المنتصرين، لا وفق حقوق المستحقين.
لقد أُفرزت إسرائيل، في هذا السياق، لا كحالة استثنائية خارجة عن القانون الدولي، بل ككيان وظيفي متكامل مع بنية القوة الجديدة التي أعادت تشكيل العالم بعد سقوط النازية. فكما أن النازية كانت لحظة انفجار مروّعة، فقد جاءت إسرائيل بوصفها التعويض المعنوي والجيواستراتيجي للغرب عن تلك اللحظة. وهي لم تُنشّأ على هامش النظام، بل في صلبه، وبمباركته، ومن خلال أدواته: الأمم المتحدة وقرار التقسيم والشرعية الأخلاقية المزعومة لما بعد المحرقة، وتحالفات الحرب الباردة.
بهذا المعنى، فإن فلسطين لم تكن أبدا، مجرد أرض محتلة، بل مرآة كاشفة لطبيعة هذا النظام العالمي، الذي لا يزال يعيد إنتاج القيم الليبرلية المتوحشة تحت غطاء الشرعية. ومن هنا، فإن تحرير فلسطين لا يمكن تصوّر أن يُنجز أبدا ضمن آليات هذا النظام نفسه، بل قد يكون رهينًا بانكسار تلك الآليات، التي قد تنتهي بولادة نظام جديد، يعيد تعريف العدل لا بوصفه امتيازا للأقوياء، بل حقّا كونيا للمستحقين، لا يسقط بالتقادم، بل يظل قائما بالعدل.
إسرائيل: البنت الشرعية للقوّة لا لشرعية العدالة:
لا يُمثّل عام 1948، في السياق الفلسطيني، لحظة احتلال فحسب، بل يُشكّل ما يمكن تسميته بـ “لحظة تأسيس للمعيار المزدوج”، حيث لم تعد الشرعية تُبنى على الحق التاريخي أو السيادة الأصلية، بل على موقع الدولة في ميزان القوى العالمية، وعلى قدرتها على انتزاع الاعتراف بقوة الوقائع لا بشرعية المبادئ. لقد كان الاعتراف بإسرائيل في الأمم المتحدة بموجب القرار 273 (1949) اعترافًا سريعًا بعد إعلان قيامها، ولم يكن تأسيسا لشرعية قيامها، رغم أن هذا الكيان قد تجاوز بعد ذلك حدود قرار التقسيم (181)، وارتكب مجازر جماعية، وهجّر مئات آلاف السكان الفلسطينيين، دون مبالاة، لا بالقرار الظالم الأصلي، ولا بالتحديد الذي حده، استبقاء لقدر شكلي من الأخلاقية الدولية المزيفة.
وبحسب وثائق الأمم المتحدة، تم الاعتراف بإسرائيل في 11 مايو 1949، بعد ضغوط شديدة من الولايات المتحدة وفرنسا، رغم اعتراضات واضحة من دول عربية وآسيوية على كونها “دولة بلا حدود محددة، ودون التزام بتنفيذ قرار التقسيم أو السماح بعودة اللاجئين”. (انظر محاضر الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الثالثة، الجلسة 207، مايو 1949).
هذا الاعتراف نفسه، لم يكن موقفًا قانونيًا بريئًا، بل كان نتاجًا لمنظومة قوة تُعيد تعريف العدالة وفق توازنات المنتصرين في الحرب العالمية الثانية. ففي الوقت الذي مُنحت فيه إسرائيل شرعية دولية باسم “التعويض الأخلاقي لليهود بعد الهولوكوست”، تم تجاهل نكبة الفلسطينيين بوصفها “تفصيلًا جانبيًا” في سردية عالم ما بعد الكارثة الأوروبية.
لم يكن الأمر متعلقًا فقط بالاعتراف الدبلوماسي، بل بتأسيس سردية جديدة جعلت من الضحية الأوروبية المخلّصة (اليهود) فاعلًا مبررًا مهما كانت أفعاله، ومن الضحية الأصلية (الفلسطينيين) عائقًا لا بد من تجاوزه. هكذا أصبحت النكبة ليست خروجًا عن النظام العالمي، بل جزءًا من لحظة ميلاده، كما عبّر إدوارد سعيد في حديثه عن “فلسطين كمرآة لعجز الضمير الغربي”.
لقد أُنجِزت دولة إسرائيل، في ظل الصمت العالمي عن التطهير العرقي، ومباركة صريحة من القوى المنتصرة، في وقت لم تكن فيه أي دولة فلسطينية قد نشأت، ولم تُوفّر الأمم المتحدة، حتى اليوم، آلية فعلية واحدة لإعادة اللاجئين أو محاسبة المحتلين. هذه الحقائق، تُثبت من جديد، أن الشرعية الدولية لم تُبنَ على قاعدة العدالة، بل على شرعية الغلبة، وعلى تطبيع القوة كبديل للحق.
النظام الدولي كمنظومة لتدوير الاحتلال:
منذ لحظة تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية، لم يكن النظام الدولي قائمًا على فكرة إنهاء الاحتلالات، بل على “إعادة تدويرها تحت مسميات شرعية، تضمن استقرار ميزان القوى لا استعادة الحقوق”. وقد مثلت القضية الفلسطينية، عبر سبعة عقود، أوضح مثال على هذا التحول البنيوي في وظيفة المؤسسات الأممية، التي تحوّلت من أدوات لإنصاف الشعوب، إلى منصات لتقنين القوة والهيمنة.
في عام 1947، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 (قرار التقسيم)، رغم أن الأمم المتحدة آنذاك لم تكن تضم سوى 57 دولة، معظمها خاضع لنفوذ الدول الاستعمارية، ما جعل القرار يمر بأغلبية غير ممثلة فعليًا للإرادة العالمية الحرة. ومع أن القرار نصّ على إقامة دولتين، فإن الدولة الفلسطينية لم ترَ النور قط، بينما حظيت إسرائيل فورًا بدعم عسكري واقتصادي، ودبلوماسي، لتتوسع على 78٪ من أرض فلسطين خلال أقل من عام.
الأكثر فداحة أن مجلس الأمن نفسه، والذي يفترض أنه الجهة الضامنة للسلم والأمن الدوليين، لم يُصدر قرارًا واحدًا ملزمًا بوقف العدوان الإسرائيلي الأول (1948–1949)، ولا ألزم إسرائيل بالانسحاب إلى حدود التقسيم، ولا بالاعتراف بحق العودة المنصوص عليه لاحقًا في القرار 194.
شواهد من أداء الأمم المتحدة تُظهر التواطؤ البنيوي:
هناك شواهد لا تعد ولا تحصى للتدليل على المشاركة المباشرة أو غير المباشرة للأمم المتحدة في شرعنة الاحتلال الصهيوني، وسنكتفي في هذه العجالة بثلاثة منها:
• القرار 194 الصادر في ديسمبر 1948، والذي نص على “حق اللاجئين في العودة”، لم يُفعل أبدًا، وظل يُعاد التذكير به في الجمعية العامة دون أثر، ما يُظهر أن الأمم المتحدة تكرّس خطابًا رمزيًا دون قدرة تنفيذية.
• القرار 242 (1967) بعد احتلال الضفة وغزة والجولان وسيناء، لم يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل بل بـ”انسحاب من أراضٍ محتلة”، بصيغة ملتبسة، سمحت لإسرائيل بتأويل القرار لمصلحتها.
• الفيتو الأمريكي: منذ 1972 وحتى اليوم، استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 45 فيتو في مجلس الأمن لحماية إسرائيل من أي قرار يُدين عدوانها أو يفرض عقوبات، ما يعني أن النظام الدولي يمنح قوى الاحتلال حق الإعفاء المسبق من القانون.
التدوير الناعم للاحتلال:
في ظل هذا السياق، أصبحت إسرائيل تُعامل كـ”دولة طبيعية في نظام غير عادل”، تُمنح حق الدفاع، وتُغضّ الطرف عن احتلالها، ويُطلب من ضحاياها أن يفاوضوا على ما تبقى لهم من حياة. وقد لخّص المفكر الفرنسي ألان غريش هذه الوضعية بدقة حين قال: “لقد باتت فلسطين مختبرًا لاختبار حدود القانون الدولي، وإذا كانت إسرائيل قادرة على تجاوز كل القرارات دون عقاب، فذلك لأن النظام العالمي لا يعمل أساسًا إلا كآلية لإعادة إنتاج القوة.” (Le Monde Diplomatique, 2002). وبالتالي، فإن النكبة ليست لحظة انفلات من القانون، بل لحظة تأسيس لنظام قانوني عالمي، يعمل ضد الضحية باسم “الشرعية”. وهذا ما يجعل فلسطين أكثر من مجرد ضحية لاستعمار تقليدي، لتتمثل ضحية “استعمار معولم” تواطأت فيه المنظومة الدولية ذاتها.
الحروب التأسيسية وصناعة الشرعية الجديدة:
يُظهر تاريخ النظام الدولي الحديث أنه لا يتجدّد عبر الإصلاح التدريجي، بل عبر الانفجارات الكونية الكبرى التي تُسقط نظامًا، وتُقيم آخر. كانت الحرب العالمية الأولى (1914–1918) نهاية لعالم الإمبراطوريات وبداية لعالم الدول القومية، لكنها لم تُنهِ الاستعمار بل أعادت ترسيمه عبر اتفاقية سايكس–بيكو ووعد بلفور. ثم جاءت الحرب العالمية الثانية (1939–1945) فأسقطت النازية والفاشية، ولكنها أيضًا أسّست لنظام استبدل الاستعمار المباشر باستعمار مُمَأسَس ضمن الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وفي هذا السياق، جاءت إسرائيل لا كحالة طارئة أو خارجية، بل كإحدى تجليات البنية الجديدة، والتي تشكّلت بعد الحرب. لقد منحتها تلك الحرب:
• مشروعية أخلاقية باسم ضحايا الهولوكوست.
• شرعية قانونية من الأمم المتحدة الوليدة.
• دعمًا عسكريًا غربيًا ضمن سردية “الحليف الديمقراطي في الشرق الأوسط”.
وبالتالي، فإن قيام إسرائيل لم يكن استثناءً، بل كان تأسيسيًا لمنظومة عالمية تقوم على ثلاث ركائز:
- الهيمنة الغربية تحت مظلة القانون.
- إعادة تعريف الضحية والمعتدي.
- تثبيت الكيان الصهيوني كعنصر وظيفي في إعادة تشكيل الخريطة الروحية والاستراتيجية للعالم.
وإذا كان النظام الذي وُلد عام 1945 قد أعاد تعريف “العدل” على أساس ميزان القوة، فإن السؤال الذي يُطرح بجرأة هو:
هل يمكن أن تسقط إسرائيل من دون إسقاط هذا النظام؟ وهل يستقيم تحرير فلسطين دون تحوّل جذري في بنية الشرعية الدولية؟
يُشير التاريخ إلى أن العدالة في النظام العالمي لا تُمنح، بل تُنتزع في لحظات التحوّل الراديكالي. فكما نشأت عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، وسقطت لتقوم الأمم المتحدة بعد الثانية، فإن ولادة شرعية جديدة تتطلب – كما يبدو – حربًا جديدة تُعيد صياغة العالم وفق مبادئ لا تُحتكر فيها القوة ولا تُفصّل فيها العدالة على مقاس المنتصرين.
هذا لا يعني تمني الحرب بحد ذاتها، أو السعي الحثيث نحو تأجيجها، بل هو مدعاة للوعي بأن النظام الدولي، كما هو اليوم، غير قابل للانقلاب من داخله، بل يُعاد تشكيله فقط حين تفشل آلياته في ضبط الصراعات الكبرى، وتنهار مفاهيمه أمام الواقع، وهوو بالذا ما نشهده اليوم في أوكرانيا وتايوان والساحل الإفريقي، وبالتأكيد هو ما نشهده بشكل أجلى في فلسطين.
وفي هذا الأفق، يمكن أن نعيد فهم معركة فلسطين لا كحرب تحرر تقليدية، بل كجبهة رمزية كاشفة لانهيار صلاحية النظام العالمي نفسه. وإذا كانت إسرائيل قد وُلدت من قلب الحرب، فإن اندثارها لن يتم إلا من خلال حرب قادمة، تفرز ولادة جديدة لنظام، لا تُصاغ فيه العدالة على مقياس الجلاد.
غزة والزلزال القادم: لحظة كشف ما قبل الانفجار:
تُشكّل غزة اليوم ما يمكن تسميته بـ “الحافة المكشوفة للنظام الدولي”. فمنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير في أكتوبر 2023، لم تعد المجازر تُخفى بأدوات التزييف، ولا الجرائم تُموّه بلغة الدبلوماسية. ولأول مرة، تسقط ورقة التوت عن المنظومة الغربية بأكملها، بما في ذلك مؤسساتها وقيمها وأحلافها، وتظهر الحقيقة العارية التالية: كون النظام الدولي ليس عاجزًا عن حماية الفلسطينيين، بل هو بالتأكيد، متواطئ في صياغة موتهم كجزء من التوازن العالمي.
لقد تجاوز العدوان على غزة أكثر من 100 ألف شهيد وجريح خلال عام ونصف، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال، فيما فُرض حصار مطلق، وتدمير ممنهج للبنى التحتية، واستهداف متكرر للمستشفيات ومراكز الإيواء ومقرات الأمم المتحدة نفسها، مع تجويع ممنهج وحاد، لشعب بأكمله، أمام مرأى ومسمع من العالم. ومع ذلك، فشلت الأمم المتحدة في إصدار قرار واحد ملزم بوقف إطلاق النار، بل في إصدار قرار ملزم لإدخال قارورة ماء وكسرة خبز، ناهيك عن عرقلت الولايات المتحدة، عبر حق النقض (الفيتو)، أكثر من خمس محاولات خلال أشهر معدودة.
شواهد على انهيار المعايير:
• في ديسمبر 2023، صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن غزة تعيش “جحيمًا على الأرض”، لكنه لم يملك أي صلاحية لفعل شيء.
• في مارس 2024، انسحبت عدة منظمات دولية من التنسيق الإنساني مع إسرائيل بعد استهداف موكب أمريكي–بريطاني تابع لـ World Central Kitchen، في سابقة غير مسبوقة.
• تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” (HRW) في مايو 2024 أكد أن العدوان الإسرائيلي يتضمن نمطًا منهجيًا من استخدام التجويع كسلاح حرب، وهو جريمة بموجب اتفاقية جنيف.
كل ذلك، ومعه صمت العالم الرسمي، جعل غزة تتحول من مجرد ساحة حرب، إلى مرآة مرعبة لوجه النظام العالمي، وبدأت تتشكل قناعة واسعة بأن:
• القانون الدولي لا يُطبَّق على الجميع.
• المظلومية الفلسطينية ليست قابلة للاستيعاب داخل هذا النظام.
• إسرائيل لا تتحدى القانون فقط، بل تثبت أن القانون ليس سوى أداة بيد الأقوى.
كما أصبحت غزة، من حيث لا تقصد، بؤرة وعي كوني تتكثف فيها كل تناقضات العالم المعاصر: بين الشمال والجنوب، وبين القوة والمعنى، وبين الصورة والحقيقة، وبين “الحرية” الغربية المركزية و”الحرية” المسحوقة في الأطراف.
وبهذا المعنى، فإن غزة اليوم لا تقاتل وحدها، بل تكشف وحدها إنها ليست فقط موقعًا للمقاومة، بل لحظة كشف تاريخية تُعري النظام العالمي من كل ادعاءاته الأخلاقية.
نحو تحرر لا يتم إلا بانهيار البنية:
إذا كان النظام الدولي قد نشأ على أنقاض حرب كبرى، وأعاد تشكيل العالم على أساس “حق المنتصر”، فإن تحرر فلسطين، بما هي نقيض بنيوي لهذا النظام، لا يمكن أن يتم عبر مسالكه القانونية أو آلياته المؤسسية أو لغته الدبلوماسية. لقد أثبتت التجربة التاريخية، منذ قرار التقسيم سنة 1947 إلى العدوان المستمر على غزة، أن هذا النظام لا يعترف إلا بما يُثبَت بقوة الواقع، ولا ينهار إلا حين تفيض الوقائع عن طاقته على الضبط والتبرير.
إن كل محاولات الحل السياسي، من مؤتمر مدريد إلى أوسلو، ومن الرباعية الدولية إلى “صفقة القرن”، أثبتت أن النظام العالمي لا يسعى إلى “حل عادل”، بل إلى “إدارة دائمة للهيمنة”، تقنّن الاحتلال وتشرعن التفوق وتجرّم المقاومة. ولهذا فإن الرهان على إصلاحه من الداخل هو رهان على نظام وُجد أساسًا لتثبيت الظلم لا لرفعه.
فإسرائيل لم تُبنَ فقط على أنقاض فلسطين، بل بُني النظام نفسه حول ضرورة بقائها، ومن ثم فإن فكّ هذا القيد التاريخي لن يتم إلا بفكّ البنية التي تصونه. ولذلك، فإن الفلسطيني حين يقاوم، لا يواجه فقط جنديًا أو مستوطِنًا، بل بنية دولية كاملة من القوانين والتأويلات والمصالح والبروتوكولات، ما يجعل تحرره لحظة انكسار ليس فقط للاحتلال، بل للنموذج الحضاري الذي أنتجه.
خاتمة: فلسطين كمؤشّر على انكسار العالم أو إمكان نهوضه:
لقد حُوّلت فلسطين، طوال قرن كامل، من قضية تحرر إلى “مشكلة دبلوماسية”، ومن مأساة إنسانية إلى ورقة تفاوض ضمن توازن القوى. ولكن ما كشفته معركة السابع من أكتوبر، وما فاض عن قدرة العالم على احتوائه، هو أن فلسطين لم تكن هامشًا في هذا النظام، بل مرآته الأكثر صدقًا، على كشف طبيعته ومآله. فإذا سقطت إسرائيل، فلن يكون ذلك نصرًا لفلسطين فحسب، بل إعلانًا عن نهاية نظام عالمي منح الشرعية للمغتصب، وجرّم الضحية، وعرّف العدالة على مقاس من يملك حق النقض لا من يملك حق العودة. وهكذا، فإن فلسطين لم تعد مجرد أرض تُحتل، بل مِفْصَلا تُقاس عنده إنسانية هذا العالم، ومتى ارتجّ هذا المفصل، عرفنا أن العالم يتهيأ إما للانكسار، أو لإعادة إحياء العدل من جديد.